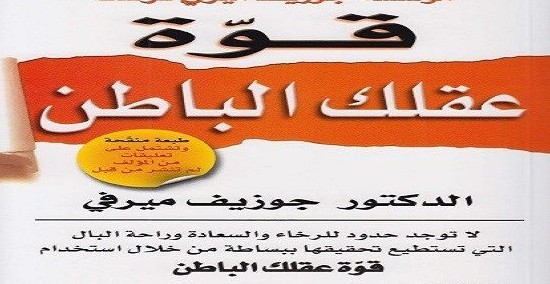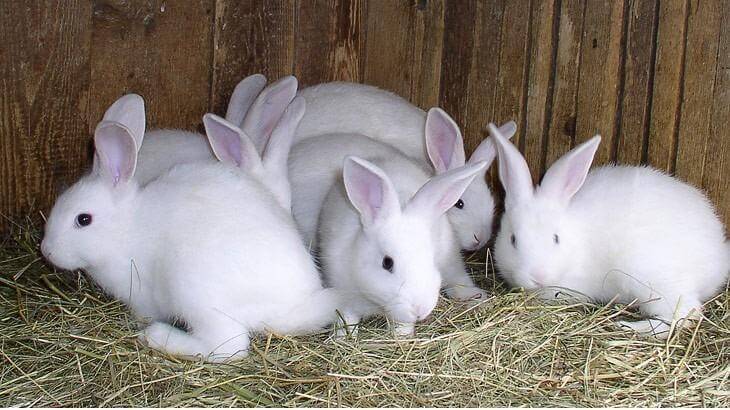المدراء الناجحون يطوّرون مهارات موظفيهم
حين شارك السباح العالمي مايكل فيلبس في دورة الألعاب الأولمبية في بيجينغ (2008)، كان هدفه النجاح في تحقيق رقمٍ قياسيٍ عالميٍ جديد. كانت تحضيراته الجسدية والنفسية ممتازة. كعادته عند كل سباق استيقظ باكراً، مارس التحمية اللازمة، ارتدى ثيابه الرياضية، ووضع نظارات السباحة وقام بكل تفصيلٍ وفقاً للخطة المرسومة مع مدربه.
أعلنَت الصافرة انطلاق السباق، قفز في الحوض وبدأ السباحة بسرعة كبيرة. كل شيءٍ كان مثالياً إلى حين نزوله إلى الحوض، حيث شعر بغشاوة في نظاراته. ارتاب قليلاً، إلا أنه آثر التركيز على السباق. تدريجياً، إزدادت الغشاوة ودخلت المياه إلى نظاراته حاجبةً الرؤية أمامه بشكل نهائي. في مواجهةِ هكذا موقف يفقِد السباح السيطرة وقد يخرج من السباق أو على الأقل قد يتشتت تفكيره وينكفئ،لكن فيلبس كان قادراً على التحكم بنفسه ومتابعة السباق لينال الميدالية الذهبية محققاً رقماً قياسياً بالرغم من انعدام رؤيته.
ليست موهبة فيلبس الفطرية وحدها قادرة على جعله بطلاً أسطورياً (حاز 28 ميدالية ذهبية)، بل لأن هناك مدرباً عظيماً خلفه.
أشرف بوب باومان على تدريب فيليبس حين كان في الحادية عشرة، أٌعجِبَ بقدراته الجسدية والرياضية المميزة، لكنه أدرك أن الصدارة تحتاج تأهيلاً نفسياً إلى جانب التأهيل الجسدي.
في كتابه "القواعد الذهبية" الذي نشر في العام 2017، فنّد باومان الآليات التي ارتكز عليها ليصنع من فيليبس بطلاً محطِّماً للأرقام القياسية. في البداية اعتمد بوب على خلق محفّزات معنوية حوّلت النشاط التدريبي المملّ إلى روتين يومي ممتع في حياة فيليبس، فأمسى التطور المستمر عادة متأصلة عنده. ثم أجبر لاعبه على تخيُّل ذاته وكأنه يشاهد نفسه في فيديو، حيث يخوض سباقاً ويصل إلى خط النهاية متصدراً. كما حفّزه على القيام بإضافات يومية للفيديو المتخيل، فمرة يتصدر برغم المنافسة الشديدة، ومرة أخرى يرى نفسه بعين فرد من الجمهور. وهكذا بات عقله الباطني مبرمجاً على الفوز. وتكمن الميزة الأهم بتدريبه لفيليبس على التعامل مع المجهول الطارئ والظروف القاسية، إذ دأب خلال حصصه التدريبية على خلق أجواء غير مريحة كإطفاء إنارة المسبح وإجبار لاعبه على السباحة في الظلمة، وهذا ما جعل الأخير قادراً على حسم الفوز دوماً.
كان من الطبيعي أن يدرب باومان سبّاحه على تحطيم الأرقام القياسية،لكنه لم يكن يستشرف المستقبل حينما دربه على السباحة في العتمة. فمن المستحيل أن يدرك أن المياه ستتسرب إلى نظاراته في بيجينغ، لكنه كان يعده لتلقف المصاعب ويحضره ذهنياً للنجاح مهما اشتدت المحن والتحديات. هذا ما يعتمده الأفراد الساعون إلى استدامة النجاح والتميّز. فلم يعد التدريب الدائم والتطوير المستمر ترفاً، إنما ضرورة واجبة لاعتلاء سلم النجاح.
في عالم الأعمال، تدرك المؤسسات التي تسعى إلى استدامة الريادة والتميز أن عليها الاستثمار في تدريب أفرادها بشكل مستمر ليبرعوا في التعاطي مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة، فيحولون التهديدات إلى فرص، ولذلك يرصدون موازنات ضحمة لحسابات تدريب وتطوير الموظفين. ولكن في عالمنا العربي، أغلب المنشآت التجارية لا تعير التدريب أهميته، وينظَر إلى بناء قدرات الموظفين العملية والذهنية على أنه أمر هامشي مكلف ومن دون جدوى.
يحسب بعض الإداريين أن نتائج فريقهم الحالية في ظروفهم الطبيعية هي معيار استمرارية نجاحهم في المستقبل، إلا أن دراسة الواقع تؤكد أن أعتى الشركات تتقهقر أمام أبسط التحديات التي تواجهها إذا لم تجد التعامل معها وتتحسب لها.
إن المؤسسات المرنة التي تجيد التعامل مع المتغيرات والقادرة على التكيف مع التطورات هي المؤهلة للبقاء في الصدارة والريادة في المستقبل. أما المؤسسات التي تنظر إلى الإنتاجية وأرقام الأعمال حصراً كمعياري نجاحٍ فمآلها الزوال ولو بعد حين، وخير مثال شركة نوكيا التي عاندت ثورة تكنولوجيا الهواتف الذكية واتخذت من أرقام أعمالها السنوية دليلاً دامغاً على صوابية خيار الهواتف البسيطة. وبعد وقتٍ قصير تراجعت وانكفأت بعدما تربعت على عرش قطاع الهواتف لسنوات. وكذلك شركة الكاميرات الشهيرة "كوداك" التي أبت مواكبة التحول الرقمي رافضةً صناعة كاميرات الديجيتال وحصرت عملها في انتاج الكاميرات التقليدية ولوازمها دون تعديلٍ نوعيٍ، فكان مصيرها الإفلاس.
الإنتاجية معيار نجاحٍ آني قد يؤنس الإدارة ويعطي إشارات جيدة لنتائج سابقة، ويدل على تفوّق في تنفيذ الآليات والسياسات الإدارية المتبعة، إلا أنه لا يؤسس بالضرورة لنجاحٍ في المستقبل في ظل احتدام المنافسة، لأن التطور السريع والتبدلات المتلاحقة يحتاجان إلى مهارات وكفايات عمل تختلف عن تلك المعتمدة في صناعة النتائج الحالية.
إن ميزة المؤسسات التنافسية في العام الحالي قد تستحيل عبئاً مدمراً في الأعوام المقبلة، إذا لم تُعدّل بما يتلاءم مع المتطلبات التكنولوجية والعلمية المستقبلية. وهذا ما يشير إليه المدير التنفيذي لـ"إدريس موتي" المتخصص في الإدارة الابداعية، عندما يبدأ المدير بقول "شركتنا تبلي بلاءً حسناً"، أو عندما تظهر علامتك التجارية على غلاف المجلات، فهذا يعني أن الوقت قد حان لبدء التفكير بالتغيير. يتعين على الشركات أن تتعلم أن نجاحاتها يجب ألا تصرفها عن الابتكار. فأفضل وقت للابتكار هو في كل وقت.
الابتكار في المؤسسات ليس وليد حاجة موقتة أو محصوراً بقسمٍ معين أو ببضعة إداريين انما هو نهجٌ وسياسةٌ تشاركيةٌ ضمن منظومة المؤسسة بحيث يصبح كل الأفراد ضالعين في مختبرات الابداع.
يرى الباحثان الأكاديميان في علم الإدارة جوزف بيستروي وديمو ديموف أن تطور الذكاء الاصطناعي في المؤسسات سيؤدي إلى إلغاء الدور التقليدي للكادر الإداري بخاصة هؤلاء الذين يتركز عملهم على مراقبة دوام عمل فريقهم وتنفيذ المهام وتقييم الانتاجيات لأن الخوارزميات البرمجية ستصبح أكثر فعالية في تنفيذ هذا الأمر منهم، ولذلك يجب أن يتمحور دورهم الجديد في العلاقات الانسانية داخل المؤسسة وإيلاء الأهمية القصوى لعاملي التحفيز والتطوير .
يذهب غاري هامل مؤلف كتاب "الديموقراطية البشرية في المؤسسات" أبعد من ذلك مطالباً المؤسسات بطرد كل المديرين لتصبح أكثر فعالية وربحية ويدعوهم إلى التحول نحو الادارة الذاتية للموظف، فالفرد قادر على القيام بدوره بشكل أفضل حينما يدرك أهداف المؤسسة ورسالتها ويشعر بأنه مشارك حقيقي وفعال في قراراتها.
انطلاقاً من ذلك يصبح من الضروري القيام بتعديلٍ جوهريٍ في دور المديرين في المؤسسات الطموحة ليصبح أشبه بدور المدرب الذي يحضر موظفيه ذهنياً ونفسياً للابتكار والخلق التطويري فلا يقيد عمله بالتركيز على تحسين اداء فريقه فقط إنما يعمد إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية في مواجهة التحديات ليتمكنوا من مجاراة المنافسة المستقبلية وتطويع المتغيرات لصالحهم، وعندها تضمن المؤسسة نجاحها وريادتها.